
عباس بيضون: “أعمال الفيسبوكيات” لا تستفزني بل تثيرني
يتعمق الشاعر والروائي والصحافي اللبناني عباس بيضون، في الحديث عن الأدب والصحافة الثقافية، إذ يقول نحن “أمام سوق ورّاقين”، مؤكداً أن “أعمال الفيسبوكيات لا تستفزني، أجد دائماً ما يستهويني أو على الأقل يستفزني أو يثيرني”.
ويتحدث كذلك عن شعراء جيله، معبّراً عن تصوره لمآلات الشعر العربي، ومسمياً المشهد الثقافي اللبناني الراهن بـ”أدب الحرب”.
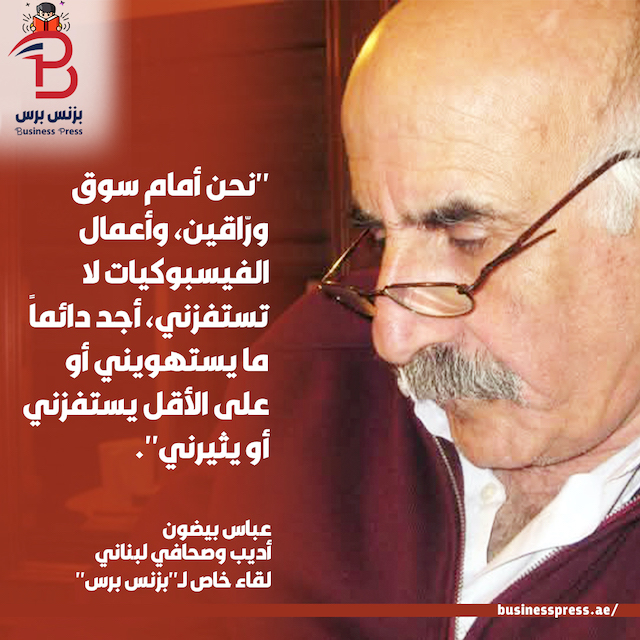
كما يتطرق عباس بيضون إلى الحديث عن الوحدة وذاكرته وعن علاقته بالكتابة والقراءة وكيف تطورت، وذلك في حوار خاص مع “بزنس برس”.
عباس بيضون، وُلد في “صور” اللبنانية عام 1945، وتخرج من قسم الأدب العربي في جامعة بيروت، وحصل على الماجستير في الأدب من “السوربون” الفرنسية، وأمضى حياته متنقلاً بين باريس وبرلين وبيروت، حيث يقيم الآن.
هو أحد أبرز رواد قصيدة النثر العربية، وأهم الوجوه الثقافية في لبنان، صدر له أكثر من خمس عشرة مجموعة شعرية منها” الموت يأخذ مقاساتنا” التي حازت جائزة المتوسط 2009، إذ ترجمت قصائده إلى الإنكليزية والفرنسية والكردية والألمانية والإيطالية والإسبانية، بالإضافة إلى سبع روايات منها ” خريف البراءة” والتي حازت جائزة الشيخ زايد للكتاب 2017.

ماذا يقول عباس بيضون عن البدايات والرحلة الطويلة في مسيرة الشعر والأدب؟
لا أذكر كيف بدأت، لقد وجدت نفسي كما صرت في وقت لا أقدر على أن أعينه وكأنني كنت فيه على الدوام.. لا أذكر متى تعلمت القراءة؛ حدث ذلك من تلقائه وكأنه كان كاملاً فيّ.
مع القراءة، سارت الأشياء من حالها، حتى الكتابة صادفتها بنفس الطريقة؛ كان أبي كاتباً، كان ذلك في العائلة ووصل إليّ كإرث عائلي.. كتبت هكذا وكأنني ألعب.
في الواقع، كانت الكتابة لعبتي؛ أنا الذي لم أعش طفولتي أو كانت لي نوعاً من محاكاة الكبار، كنا نلعب الخطابة، وفي سن أخرى بدأنا نلعب الكتابة.. لعب الكبار وبقينا على لعبنا حتى كبرنا.
كان لدى أبي مكتبة عامرة نسبياً. بين كتبها دواوين المتنبي وابن الرومي وأحمد شوقي. وكنا في لعبنا نختلف بهذه الكتب ونقرأ منها بصوت عال، وأظن أننا بدأنا نكتب على هامشها، وحين سمعنا بنزار قباني في (أنت لي) و(قصائد) نفس الشيء. انتقلنا إلى القصيدة الحديثة بالطريقة نفسها.
أتكلم الآن على ثلة لم يبق أي منها مسمى ككاتب.. كنا أربعة أو خمسة ولعبنا جمعية أدبية. في ذلك الوقت كنت عند نفسي كاتباً أقول كاتباً، بدون تحديد النوع، لكني لم أكن متأكداً من أنه الشعر.
في الحقيقة، لا أذكر متى اخترت الشعر. بقيت وقتاً أكتب كل شيء. كنت في الثالث تكميلي حينما هبط عليّ الشعر. أظن أنني وقفت حينذاك عند قباني وحجازي وذلك الشاعر الذي فتنني بـ(نهر الرماد).
صرت شاعراً بدون أن أتوقع ذلك، لقد كانت لعبة بقيت عندها، لكنني مع ذلك كنت عند نفسي أكثر من شاعر. لقد كان الوقت لثقافة شاملة. كان الشاعر والمفكر وربما الداعية في شخص واحد. كان علينا أن نقرأ بصورة خاصة “ماركس” و”لينين” و”ماو”، هكذا نملك مفاتيح العالم.
فعلت ذلك ومتابعته، فقد وجدت “غرامشي” و”ألتوسير” و”لوفيفر” وسواهم. هكذا لم أعد فقط شاعراً. جمعت إليه الناقد والمفكر. كان هذا يعطي للشعر نفسه وزناً آخر أو يدعمه ويمنحه عمقاً وسعة لا يعود بهما فقط شعراً. كانت القراءة نزهتنا وكنا بها نغدو شاملين، نصنع المستقبل أو نطل عليه. كان هناك مكان مرصود ينتظرنا. وكنا نجده أمامنا ونجد شركاءنا فيه بدون تعب. نصل هكذا إلى مكان خاص. نحن معدون له بدون تعب. ونبلغه على طريقنا. كنا ممتلئين من أنفسنا وواثقين بها، فنحن هكذا أمام التاريخ ولنا أفق محسوب ينتظرنا والأمور متسقة صاعدة على رسلها، وستصل تلقائياً إليها.
تعد من شعراء الجيل الثاني الذين صنعوا قصيدة النثر العربية.. أين يقف هذا الجيل اليوم؟
قلت قبل الآن أيضاً، إن الجيل الثاني من شعراء قصيدة النثر هو الذي صنع قصيدة النثر كقصيدة، الجيل الذي سبقه كانت قصيدة النثر دعوته وبيانه..
يمكننا القول إن الجيل الرائد اقترح شعر النثر أو الشعر بالنثر، لكن ما كان يصنعه هو ملحمته. هذا بالتأكيد كان طموحاً جداً وكان مغامرة شاملة، لكن النص نفسه كان في مباراة مع قصيدة الوزن جعلته من ناحية ما محاكاة بعيدة لها أو نقضاً يمتد بإزائها وفي موازاتها أو يكون مصداقاً لدعوة مفترضة فيها.
هذه المعارضة لقصيدة الوزن أثقلت كاهلها وحرمتها تقريباً من أن تجد نفسها أو تخلق نموذجها. لقد كانت حبيسة معركتها؛ تلك التي جعلت نصها ابن مباراة تنتهي بمغالبة النص الموزون أو نفيه، في الحالين بقيت تحت النص النقيض أو في مواجهته.
قصيدة الجيل الثاني لم تكن هذه معركتها ولا كان هذا طموحها. كان أمامه أن توجد لنفسها أن توجد أولاً كقصيدة. أن تبنيها بدون الضياع في المعركة مع النص المضاد أو مباراته. كان لديها عالم لها وواقع أمامها.
انتهى لذاك الطموح الملحمي وروح المباراة. كان على قصيدة النثر، أن تكون ما يعنيه النثر ليس فقط في اللغة، ولكن أيضاً في المكان وفي الوقت. كان ممكناً لذلك ابتداء نص آخر، خاص ومستقل، يمكننا هكذا أن نتكلم عن المدينة وعن الحاضر.
يمكن القول إن الجيل الثاني هو الذي صنع النثر كقصيدة، إما أن الجيل الثالث وجد هكذا ما يبني عليه وما يسترسل فيه المدينة والحاضر والنثر. إنه عالم لا يزال يواجه ويسعدني.
من الحرب الأهلية اللبنانية إلى حرب لبنان الراهنة.. كيف ألقت تلك الحروب والصراعات ظلالها على المشهد الثقافي اللبناني الراهن؟
يمكننا أمام سؤال معقد كهذا أن نقول في عبارة واحدة إن الأدب الراهن في لبنان هو أدب الحرب؛ بل نقول إن لبنان الذي نعرفه هو ابن الحرب. لبنان هذا صار له تاريخ بدأ من الحرب الاهلية، بل صار له بهذه الحرب، مشروع وجود. الرواية اليوم هي رواية الحرب، وإذا كان من الصعب أن نتكلم عن الشعر بنفس الطريقة، فإن في وسعنا أن نتكلم هكذا عن الرواية.
تقول “أعيش محاطاً بكل هؤلاء الذين تركوني وحيداً”.. ماذا تخبرنا اليوم عن تلك الوحدة؟
أعيش محاطاً بكل هؤلاء لنقف عند بكل وهؤلاء؛ الوحدة تتم وسطهم.. إنها نوع من الضياع فيهم؛ لا أزال أتكلم على النحو نفسه، لي أيضاً هذه الوحدة التي هي مصداقية الجمع والكثرة. إنها وحدة ملزمة، وحدة ملازمة لوجودنا بل هي سؤاله.
إلى جانب الشعر والرواية، مارست الكتابة الصحفية لسنوات طويلة.. ما دور المحرر في إرساء ثقافة أصيلة؟
يمكننا أن نتكلم هكذا عن الثقافة الصحفية، لا نستطيع عند ذلك أن نتكلم بسهولة عن أصالة، نحن هكذا بالعكس أمام تقليد بحت أمام ثقافة وراقين، حيث في الأغلب هناك خطاب شبه عامي أو عامية تنتحل لنفسها اسم الثقافة.
ما يكتبه اليوم ضمن قصيدة النثر العربية كتاب شبان عبر فضاءات إلكترونية، كيف تقرؤه؟
أقرأ هذه القصائد أجدها في الأغلب حية وواعدة، هناك ما يجعلني أشعر أن كثرة من الكتاب يشقون لأنفسهم تجارب خاصة مبتكرة وخلاقة. الشعر هكذا يملك مازال مداه وباعثه.
في خضم التحولات المؤلمة في المشهد الأدبي العربي، حيث يصف البعض أن الأدب بات جزءاً من ثقافة الاستهلاك السريع.. وبينما تتزايد هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي والبزنس على الأدب، على مَن يقع مسؤولية الحفاظ على جودة الأدب؟
هذه حال دائمة، هناك باستمرار أعمال كثيرة وقلة مبدعة، ليس في الأمر ما يخيف، لا أظن أن هناك مشكلة بهذا الصدد. أعمال الفيسبوكيات لا تستفزني، أجد دائماً ما يستهويني أو على الأقل يستفزني أو يثيرني.



